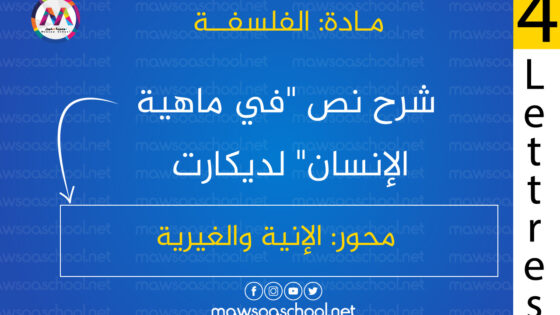ملخص رسالة الغفران: القضايا – العربية – بكالوريا آداب
القضايا الدينية:
التوبة:
التوبة عندهم مفهوم باطل بأنها قول يقال ويشهد عليه شهود وإنما هي التوبة الحقيقية ميثاق بين الله وعبده فأبو العلاء يسخر من فكرة التوبة التي راجت بين أوساط العامة كسخريته من “ابن القارح التي جاءت توبته بأخرة من الوقت”.
الغفران:
يرفضها أبو العلاء المعري لتناقضها مع مفهوم العدل الإلاهي لأن الله قد وهب الإنسان العقل وبعث إليه الأنبياء فلم يعد داع من المغفرة فيؤخذ حينها على الحساب والجزاء.
الشفاعة:
يرى المعري أن تصور الشفاعة أيضا يتناقض مع مفهوم العدل الإلاهي إذ كانت الشفاعة في تصورهم تطلب من الرسول لتشمل آل البيت وتتسع الدائرة لأهل قريش فالشفاعة وسيلتها الكلمة الطيبة فمن أراد الشفاعة يأخذ بقول حسن مخالف به تعاليم الدين سلوكا وعملا وعلى سبيل الذكر “الأعشى” يدخل الجنة لأنه مدح الرسول في الدار العاجلة بعد أن حكم عليه بالإلقاء في الجحيم وبذلك ابطال الحكم الإلاهي وقد كان سكيرا عربيدا في الدنيا كافرا رغم بلوغه الإسلام محبا للخمرة فأُدخِل الجنة رغم ضعف الحجة وعدم معقوليتها إلا أنه مدح الرسول ويظهر هذا الموقف بالرفض في استنكار النابغة الجعدي وجوده بالجنة إذ يقول:” أتكلمني بمثل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة وقد مت كافرا وأقررت على نفسك بالفاحشة … لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من النار … ولو جاز الغلط على رب العزة لقلت إنك قد غلط بك”.
وعلى غراره نجد ابن القارح بعد سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة مع رضوان وزفر وحمزة يدخل الجنة بتوجهه إلى فاطمة فالرسول وفي الأخير شفع له لأنه في الدار العاجلة كتب كتابا وفرغ منه بقوله:” وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى عترته الأخيار الطيبين”
وإن ما فيه من رفض هو أن الشفاعة بهذا الشكل اعتراض على حكم الله ومشجعة الإنسان على اقتراف الذنوب والمعاصي وتواجد الكافر كالأعشى والصحابي كالنابغة الجعدي في نفس المكان.
إنه رد كذلك على بعض المذاهب الدينيّة و في مقدمتهم الشيعة الذين يؤمنون بالشفاعة و يعلقون عليها آمالهم للفوز بالجنة كأن لا علم لهم بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه﴾ وقوله ﴿ليس لهم من دونه ولِيّ و لا شفيع﴾ و قوله ﴿ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه﴾ ﴿لا تغني شفاعتهم شيئا إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء﴾ و عديدة هي الآيات التي تدور في هذا الفلك.
معتقد التعويض:
طرح المعري تصور العوام لمعتقد التعويض بأن يحقق الإنسان في آخرته ما كان ينقصه أو يشكوا منه أو غير ذلك فمنهم من يرى أن مسألة التعويض هي نابعة عن العدل الإلاهي فما نقص في الدنيا يكتمل في الأخرة وما استقامت له يلقى في الأخرة بؤسا وشقاء كحال الملوك وأولادهم ونسائهم بينما صار الأعشى بعد شيبه وانحناء ظهره شابا غرانقا …. وكذا الحال مع زهير ابن أبي سلمى الذي يشتكي في دنياه من الهرم “فإذا هو شاب كالز هرة الجنية … كأنه ما لبس جلباب هرم” وبعض نساء العامة مثل حمدونة الحلبية التي طلقها زوجها لرائحة كريهة فيها فصارت “كأنها الياقوت والمرجان” والأخرى توفيق السوداء التي صارت أنصع من بياضا “أصبحت أنصع من الكافور” ومثل عوران قيس “فهم أجمل أهل الجنة عيونا”. ولما فيه من تكريس للموجود والرضا به.
قضايا غيبية شغلت عقله:
أعمل المعري عقله في مسائل غيبية من المسكوت عنها ومما لا يباح فيها الكلام إلا للراسخين من العلم كطرحه لمسألة البعث وكيفيته هل يكون روحا فقط أم جسدا فقط وإن كان البعث يجمع الروح والجسد فماهو المكان الذي يتسع لكل هذه الموجودات من الأجساد وغيرها “لما نهضت أنتفض من الريم…” ومن ذلك يرى المعري أن القول ببعث الجسد قول باطل باعتباره عنصرا مدنسا فهو من الأرض وإلى الأرض وأما الروح من السماء وإلى السماء لذلك من غير المعقول القول ببعث الأجساد بل إن بعثها بعث للشهوات والرغبات في الجنة التي هي موطن الدنس مما يجعل الجنة فضاء لتحقيقها من ذلك ابن القارح بعث جسدا نقل معه شهواته ورغباته إلى السماء وعلى غرار هذا التسائل الذي ظل في الأخير موقفا لا يحتمل وضوحا كذلك الحال في مسألة الكيف في العذاب والنعيم هل تكون كيفيتهما مادية أم معنوية من صنف نجهله فإن كانت مادية حينها تصبح الجنة كالأرض جنة موبقات وإن كان العذاب ماديا فإبليس من نار فكيـف يعذب بالنار؟ ويطرح أيضا المعري مسألة جزاء المرأة في الآخرة كيف يكون هل تبقى على حالها في الدنيا؟ . فيسأل عن جزاء المرأة ما هو إذا كان للرجل الحور والولدان والغلمان…
ويتسائل المعري أيضا عن ما حرم في الدنيا حلال في الآخرة من ذلك تحليل الخمرة في الجنة بسر الكتاب فهل يحلل اللواط في الآخرة مثل الخمرة ” إن الخمرة حرمت عليكم في الدنيا وأحلت لكم في الآخرة فهل يفعل أهل الجنّة بالولدان المُخلدين فعل أهل القريات”.
قضية الجزاء هل تقتصر على المكلفين من العاقلين المسلمين أم تشمل الحيوان كأسد القاصرة وذئب الأسلمي؟ وما هو مصير الذين لم يدركوا الإسلام وكانوا على الحنيفية؟
القضايا الأدبية:
تقديم حد الشعر:
طرح المعري مسألة الشعر في تقديم تعريف جديد له يحتل فيه الذوق مكانة هامة فالشعر عند المعري “الأشعار جمع شعار، كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس” وهذا التعريف قدمه المعري على لسان ابن القارح. متجاوزا بهذا التعريف التعريفات السابقة أمثال تعريف “قدامة ابن جعفر” الذي يعرف الشعر بقوله :” الشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى” فالمعري يلح على الموهبة من جهة وعلى اللذة من جهة أخرى وفي ذلك اعتراض عن القواعد العروضية التي سنها الخليل الفراهيدي فصار مقيدا للإبداع والحرية في الفن وقد وجد من الشعراء من خرج على البحور ومن ذلك “أبي العتاهية” فقد قال شعرا على غيرها فأنكر عليه أناس كثيرون فقال:” أنا أكبر من العروض”.
مسألة الكم والكيف في الشعر: مسألة مقياس نقد الشعر:
يطرح المعري على غرار تعريف الشعر، مسألة مقياس نقد الشعر وهو ما شاع في عصره من مقاييس وهي الكم والكيف وقد وردت هذه المسألة في رسالة الغفران في حوار المفاخرة والمخاصمة التي دارت بين لأعشى والنابغة الجعدي.
مقياس الكم: من أنصاره النابغة بن جعدة إذ يقول في هذا “إني لأطول منك نفسا أكثر تصرفا ولقد بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه أحد من العرب قبلي” إذ يرى جودة الشعر في طول النفس وعدد البيوت وسعة التصرف في اللغة والمعاني والقدرة على تمطيط القول.
مقياس الكيف: ومن أنصاره الأعشى الذين يرفضون الطول في النفس الذي يذهب إلى تركيم اللغة يقول الأعشى في ذلك مخاطبا النابغة الجعدي بعد احتداد الخصومة “وإن بيت مما بنيت يعدل مائة من بنائك وإن أسهبت في منطقك فإن. المسهب كحاطب الجبل”.
بعض منهم قام على الإسهاب والأخر على الجودة وكان المعري من أصحاب الجودة الرافضين للإسهاب الذي ينزل بالشعر إلى درجة الإسفاف بصفة غير مباشرة.
السرقات الأدبية:
تمثلت هذه المسألة في السطو على شعر اﻷخرين مثل ابن القارح في مشهد الحشر وهو يحاول إرضاء رضوان خازن الجنان بأبيات امرؤ القيس حيث استبدل وغير بعضها ونسبها لنفسه يقول:” زينت لي النفس الكاذبة ان أنظم أبيات في رضوان خازن الجنان وجعلتها في وزن: قف نبكي من ذكرى حبيبي وعرفان” وفعل كذلك في شعر جرير.
نقد النحاة:
غير بعض النحاة الشعر حسب مقياس قواعدهم النحوية فانتهوْا إلى تأويلات بعيدة عن الأصل بل تدل أحيانا على الهذيان وليس حسب ما يناسب النظم الشعرية عند العرب فاللغويون والنحاة مثلوا سلطة فوق سلطة الإبداع “أمجنون انا حتى أعتقد ذلك!؟” كقول ابن القارح في سؤاله للغويين ” ما موضع يطمئن في قوله ولكن ليطمئن قلبي”فيصل إذن النحاة إلى تأويلات غريبة بعيدة عن الشائع والمألوف وقد أنطق الشعراء تمردا على النحويين مثل أبي على الفارسي إذ نقل ابن القارح مجلس أستاذه قائلا “وإن جماعة من هذا الحديث يلومونه على تأويله”.
نقد شعر التكسب:
اتخذ المعري من كتـابة الرسـالة مطية للتعبير عن مواقفه إزاء بعض القضـايا التـي تمس الأدب و الشعر خاصة فأبان عن ازدرائه لمسألة التكسب بالشعر و إراقة ماء الوجه لقاء عطية تعطى أو هدية تهدى يقول مثلا على لسان إبليس معلقا على قول ابن القارح: “أنا فلانُ ابن فلانٍ من أهل حَلَبَ كانت صناعتي الأدب أتقرّب به إلى الملوك فيقول: بئس الصناعة إنها تَهَبُ غفّة من العيش لا يتسع بها العيال و إنها لمزلة بالقدم و كم أهلكت مثلك…”.
يرى أبو العلاء المعري أن شعر التكسب بما هو شعر المديح تحسين لما قبح وتجميل له فهو ممزوج بالكذب ولما آل إليه وظيفة الشعر ليصبح غاية قائله بلوغ المادة ليكون وسيلته في التكسب لا بغية وظيفة فنية جمالية “وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات” فيصبح فنا كاذبا لا علاقة له بالقيم والصدق ومما نراه أيضا من ذلك أخذ ابن القارح مدحا في رضوان خازن الجنان شعرا متكسبا به لاستمالته “زينت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبيات في رضوان خازن الجنان جعلتها في وزن: قف نبكي من ذكرى حبيب وعرفان” ويرى ان هذا المديح لا يصدر إلا عن نفس كاذبة وهذا ما اعترف به ابن القارح بهذه الصفة على لسانه في قوله الآنف الذكر ويعتبر النابغة الجعدي ان شعر التكسب شعرا ناقصا يستغل لمآرب وغايات حيث يقول “ولأنت لاه في بعفارتك تفتري على كرائم قومك وإن صدقت فخزيا لك ولمقارك”
وقد شبه المعري شاعر المديح بنبيح كلب على لسان النابغة الجعدي عند خصومته مع الأعشى الباحث عن فضلات أسياده ” لقد وقفت الهزانية في تخليتك. عاشرت منك النابح عشي فطاف الأحوية على العظام المنتبذة” ويتجلى هذا الموقف أيضا في مشهد الحشر مع ابن القارح في مدح حمزة فيعتبره دنسا لا يتماشى مع رفقة المكان وعظمته “ويْحَك أفي هذا الموطن تجيئني بالمديح”.
مسألة الشعر المنسوب إلى الجن وءادم:
عمد المعري إلى التشكيك في صحة الشعر المنسوب إلى الجن ولأدم الذي نسبوا إليه هذا البيت:
منها خلقنا وإليها نعود – نحن بنو الأرض وسكانها
فكشف المعري عن موقفه من قضية الانتحال في الشّعر يقول على لسان آدم وقد أصرّ ابن القارح على نسبة بعض الأبيات من الشعر إليه رغم رفضه:” آليت ما نطقت هذا النّظيم ولا نُطقَ في عصري و إنّما نظمه بعض الفارغين…”
ويرى أن بني أدم قد أمعنوا في الكذب وهي رواية أبطلها المعري على لسان أدم مستعملا منزعا عقليا يستدعي مراجعة التاريخ الثقافي العربي وتنقيته من شوائب الكذب والافتراء من ذلك أن الكلام المنطوق به باللغة العربية بينما أدكم لم ينطق بها إلا في الجنة وإن قالها في الجنة فإنه قول باطل من ذلك أن أدم عندما كان في الجنة لم يكن ليغرف الموت بعد عودته من رواه عنه ومن أتى من الجنة بهذا الخبر.
القضايا الاجتماعية:
الوساطة في المجتمع:
مثلت رحلة الغفران فضاء نقل فيه المعري ما ساد فيه من مظاهر اجتماعية كالوساطة التي تجلت خاصة مع ابن القارح الشخصية المحورية في الرحلة وتظهر الصورة في تعجله الدخول إلى الجنة ولم يتسنى له ذلك إلا بعد وساطات متتالية ومتعددة يقول المعري على لسان ابن القارح:” فوقفت عند محمد فقال من هذا الأتاوي؟ أي الغريب فقالت فاطمة هذا رجل سأل فلان وفلان” وبدأ الوساطة برضوان خازن الجنان وزفر فحمزة فعلي وهكذا. ويرى أن الوساطة هي تعبير عن واقع تتدخل فيه الحاشية والمقربين في القرار والسيادة مما يتناقض مع العدل.
الطبقية في المجتمع:
وضع المعري الجنة على درجات فمن ساكنيها من منهم ينعم بالنعيم والملذات كزهير الذي وهب قصرا “وهب قصرا من ونية” وكذلك الحال مع النابغتين ولبيد وخاصة ابن القارح يسكنون الفراديس ولهم عبيد وحواري يخدمونهم يقول: قالت فاطمة الزهراء: عليها السلام:” قد وهبنا هذه الجارية فخذها كي تخدمك في الجنان” “فهذه فاطمة الزهراء تهب لابن القارح جارية” وغلمان وولدان بينما يكون الحطيئة في أقصى الجنة أو في طرفها في كوخ مظلم بائس ” فإذا هو ببيت كأنه خفش أمة راعية وفيه رجل ليس عليه نور اماه شجرة ثمرها ليس بزاك” فهي صورة عن واقع أليم في الدنيا أبعدت ليظهر الخلل فيها وعزبت تقية وذلك لصدقه في شعره.
وضعية المرأة:
اقتصر دور المرأة في الغفران على تقديم الملذات والمتعة لأهل الجنة أو الوساطة لابن القارح كما كان الحال مع فاطمة وجاريتها يقول المعري على لسان ابن القارح:” فوقفت عند محمد فقال من هذا الأتاوي؟ أي الغريب فقالت فاطمة هذا رجل سأل فلان وفلان” قالت فاطمة الزهراء: عليها السلام:” قد وهبنا هذه الجارية فخذها كي تخدمك في الجنان” “فهذه فاطمة الزهراء تهب لابن القارح جارية” وهو ما يدل على دور المرأة السياسي في البلاطات وتدخلها في الحكم زمن الدولة العباسية ويطرح أيضا المعري مسألة جزاء المرأة في الآخرة كيف يكون هل تبقى على حالها في الدنيا؟ .
نقد قيم المجتمع:
ضعفت القيم الفاضلة في زمن المعري لتحل محلها قيم مذمومة مثل الكذب “زينت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبيات في رضوان خازن الجنان” أو الرياء أو الخداع حتى يصبح الصدق يجازى عليه بالمكانة الحقيرة شأن الحطيئة في حين يفوز غيره بفردوس الجنة بنفاقهم وتحيلهم وكذبهم وجحودهم أمثال ابن القارح وتظهر هذه الصفات في مشهد الحشر.
نقد السرف والبذخ:
نقل لنا أبو العلاء المعري مآدب السادة حيث تتسم بالبذخ و الإسراف وفي المقابل يجوع العامة ومنها المآدب التي أقامها ابن القارح في الجنة التي حملت أصنافا شتّى من المشروبات والمأكولات وأضحت جنة الغفران “مهرجانا خمريا” على غرار ذلك تحضر المتعة الجسدية فقد عرض لنا المعري نهم الرجل العربي على الرغبة الجنسية وذلك في عرض دور الجواري والحور العين خاصة في موقفهم مع ابن القارح التي لا تكاد أن تنطفئ فيه هذه الرغبة إذ يجمع بينه وبين حورتين ” ويخلو لا أخلاه من الإحسان بحوريتين من حور العين .. ويقبل على كل واحدة منهن يترشفُ رضابها “.
القضايا السياسية:
موقفه من الساسة:
لقد أبدى المعري موقفه من الساسة في رسالة الغفران وكان موقفا واضحا وجليا في اللزوميات فقد عاب عليهم سياستهم التي تقوم على الهفوات والهوى والنزوات فهم من العقل خلاء فقال:
فينفُذُ أمرُهم ويقالُ ساسَهْ *** يَسوسونَ الأمورَ بغَيرِ عَقلٍ
ومن زمَنٍ رئاستُهُ خَساسَهْ *** فأُفَّ من الحياةِ، وأُفَّ مني
وفي رسالة الغفران يعمد المعري إلى إدخال الملوك وذويهم النار دون استثناء وأمعن في تصوير ما يلقونه من العذاب إذ يقول:” والشوس الجبابرة من الملوك تجذبهم الزبانية إلى الجحيم والنسوة ذوات التيجان يصرن بألسنة من الوقود فتأخذ في فرؤهن وأجسادهن فيصحن: هل من فداء؟ هل ن عذر يقام؟ والشباب من أولاد الأكاسرة يتضاغنون في سلاسل من النار”.
الجوسسة المنتشرة في البلاطات:
يكشف لنا المعري حقيقة ما يدور في البلاطات من الخيانة والجوسسة ويشير إلى رفع الكلام إلى الساسة والحاكم وهي ظاهرة قد انتشرت في زمن المعري فللسلطان عيون متنقلة خفية تدري ما لا يعلمه المرء عن نفسه ويقول المعري على لسان ابن القارح وهو بصدد الإصلاح بين الندماء:” يجب أن يحذر من ملك يعبر فيرى هذا المجلس فيرفع الحديث إلى الجبار الأعظم فلا يجر ذلك إلا إلى ما تكرهان”.
التدخل في الحكم:
تتجلى هذه القضية في تدخل الحاشية وذوي السلطان في الحكم ولما فيه من تغييب فعل الخليفة وأمره وتركها إلى الأمراء من البوهيين الذين ينقضون أحكامه فهم الفاعلون الغافرون الراحمون المعاقبون وتتجلى صورة تدخل الحاشية في حكم الخليفة من خلال قصة الأعشى الذي صدر فيه الحكم من قبل الله بدخول الجحيم “سحبتني الزبانية إلى النار” لكن هذا الحكم يبطله محمد بواسطة علي زوج فاطمة ومن ذك أيضا ابن القارح الذي شفع له من قبل الحاشية لما وقف بين يدي الرسول فقال: فوقفت عند محمد فقال من هذا الأتاوي؟ – أي الغريب فقالت فاطمة هذا رجل سأل فلان وفلان وسمت جماعة من الأئمة الطاهرين ” فشفع له ومشهد الحشر يغيب فيه الرب أي الخليفة فلا يسمع أمره ولا حكمه ونسمع صوت وحكم امر الحاشية والمقربين للخليفة ليحمل الأخير وظيفة شكلية وفي هذا النطاق يتعمق المعري في الأوضاع السياسية ليشير إلى ما آل إليه الوضع في عصره في تدخل المرآة في البلاطات وتوجيه السياسة التي شهدت في عصره تدخل الجواري والنساء في شؤون الحكم بل إن المهزلة في شؤون السياسة تطل من خلال تدخل الصبيان في الحكم من ذلك أن دخول ابن القارح الجنة كان على يد صبي وهو إبراهيم ابن محمد الذي تعلق بركاب خيله يقول في ذلك المعري:”ثم جذبني جذبة حصلني بها في الجنان”.
علاوة على توتر العلاقة بين الراعي والرعية فالإله غائب والحاشية حاضرة في الواجهة مثلت فيصلا بينهما.
المراجع:
العمل التحضيري لشرح النصوص للأستاذة حياة المؤدب بمعهد ابن خلدون برادس.
عمل تأليفي لرسالة الغفران لتلاميذ البكالوريا، للأستاذ: الأزهر بن رحومة.
كتاب، دراسة رسالة الغفران، للأستاذ ” محمد الهاشمي الطرابلسي”، مطابق للبرنامج الرسمي.
أنجز هذا العمل من قبل أشرف البنزرتي – بكالوريا آداب
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني